שווה לחשוב על זה | בלוג | עמותת קדמה לשוויון בחינוך | 27.06.2024
0 צפיות | אין תגובות
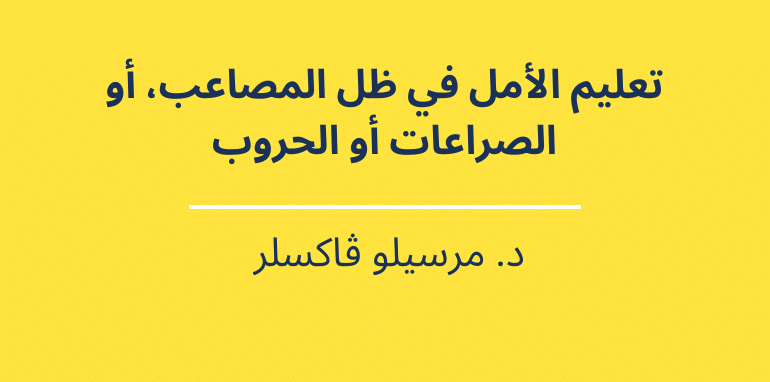
في الفترات العصيبة التي نعيشها، سواء في محيطنا أو في عملنا التربوي، في المدرسة أو رياض الأطفال، من المهم تذكُّر وتفعيل قدراتنا على إنشاء أطر من الأمل.
في البداية علينا تعريف بعض الافتراضات الأساسية:
كل علم تربية (بيداغوجيا) هو تصوّر أيديولوجيّ. أي أنه هو العقيدة الذاتية التي نحاول وفقًا لها تفعيل التربية. إنّ العمل التربوي هو عمليّة عطاء لشخص آخر أو أشخاص آخرين. بهذا المفهوم، فإن معنى المصطلح "تعليم الأمل" أو "بيداغوجيا الأمل" هو تصوّر أيديولوجيّ نرغب، نحن المعلمين والمعلمات، أن نوصل بناءً عليه رسالة إلى طلابنا وطالباتنا، بغض النظر عن أعمارهم.نّ.
أي أنّ الرسالة مفادها أن هناك أملًا في الإطار الذي نتواجد فيه. والأمل يستند على الإيمان وعلى التغيير. ليس على الوهم بأنه بواسطة تعليم الأمل فإن كل العالم من حولنا سوف يتغير، وإنما من منطلق أنّ كلّ ما يمكننا منحه في الإطار الخاص بنا سيعطي أملًا لطلابنا وطالباتنا نحن. مما يعني أن هذا هو أمل محدّد وليس أملًا للمجتمع عامةً.
لماذا كلّ هذه الأهمية في تحديد بيداغوجيا الأمل؟ لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكننا من بناء خطة عمل قابلة للتنفيذ تتيح لنا إيصال رسالة الأمل. فيما يلي بعض المبادئ المهمة وبعض التقييدات التي ينبغي أن نأخذها بالحسبان:
الإيمان
نقطة انطلاقنا هي أن لدينا إيمانًا كاملًا في قدرتنا على التأثير على جميع طلابنا وطالباتنا. هذا الإيمان ليس مشروطًا بقدرتنا الحقيقية على تغيير تصرفاتهم/نّ، وإنما بقدرتنا، نحن المعلمين والمعلمات، على دفعهم/نّ إلى التغيير.
في كل حال وتحت أي ظرف سوف نستثمر أقصى ما يمكن، من منطلق الإيمان بالقدرة على التغيّر بالاتجاه الإيجابيّ. هذا معناه أنّ الإيمان الذي يبعث الأمل هو العمل التربوي الذي يتيح التغيير السلوكيّ لدى طلابنا وطالباتنا، رغم حالة الأزمة التي يعيشونها/ يعشنها، هم/نّ وعائلاتهم/نّ ومجتمعاتهم/نّ.
لا نفعل ذلك من أجل إخفاء الواقع وإنما من أجل تزويد طلابنا وطالباتنا بأدوات لمواجهة ذلك الواقع العصيب ذي الإسقاطات الفعلية على سلوكهم/نّ اليومي. (التسرّب العلني أو الخفيّ، ظواهر العنف، هبوط بالتحصيل الدراسيّ، تزعزع الثقة بالجهاز التربوي أو الأجهزة الجماهيرية بشكل عام، وغير ذلك).
الإيمان إذًا يساهم في بناء إطار مؤسساتيّ يتيح لقواعد "تعليم الأمل" أن تطبّق فيه.
الأمل يُبنى في نفس الوقت مع أهداف وحدود:
عندما نتحدث عن تعليم الأمل فإننا نؤطر رسائلنا في مجالات قابلة للتنفيذ من ناحية الأهداف والحدود. على الأهداف أن تكون واضحة للطلاب والطالبات، مثل: تحصيل دراسيّ، تصرف بمسؤولية متبادلة فيما بينهم/نّ، تنمية التعاطف والتسامح تجاه المختلف عنّا، تحمل المسؤوليّة عن الأفعال وعن الإخفاقات، الإدراك بأن ليس كلّ عمل مفروضًا مسبقًا، وأن هناك حالات سيدوم فيها شيءٌ من عدم اليقين، والعكس صحيح، هناك أفعال من شأنها خلق المزيد من الثقة والأمل.
وبموازاة الأهداف، قصيرة المدى أو طويلة المدى، هناك حاجة لوضع حدود. فإنّ تبيين الحدود واستيعاب الحدود هو جزء من تطوّرنا كبشر. وكما أننا ملزمون في العيش داخل حدود، علينا أن ندرك أيضًا أنه في غياب الحدود سيكون إيذاؤنا لأنفسنا وبيئتنا أشدّ قسوة. إن الحدود هي حاجة وليست عقابًا بحد ذاتها. وهي تتيح لنا أن نفحص بأنفسنا قدرتنا على العيش داخل دوائر بشرية، وكذلك اختبار قدرتنا على التعامل مع التقييدات. هذا جزء لا يتجزّأ من التلمذة، ومن برنامج كل إطار يتمّ فيه التعليم على تحقيق الأهداف. إن تحديد الأهداف بدون تعيين الحدود سيؤدي إلى تفكيك المسيرة التعلّميّة وإلى الإحباط. وإن تعيين الحدود بدون تحديد الأهداف سيفسّر، وبحق، على أنه مجرد قسوة من قبل المعلمين/ات.
عندما لا يستطيع/ تستطيع طالب.ـة أن يتعامل/ تتعامل – عمومًا – مع الحدود المطلوبة، فهذا معناه أنه/ أنها يرفض/ ترفض أن يكون/ تكون جزءًا من الإطار على كلّ إيجابياته وكلّ تقييداته. نحن لا نتحدث هنا عن عدد "الفرص" التي سنعطيها للطالب.ـة. هذا جزء من استراتيجية المؤسسة وجزء من الإدراك أن لكل طالب وطالبة وتيرة خاصة به/ بها وحساسية خاصة به/ بها. لذلك ينبغي على المؤسسة أن تناقش الأمر بعمق. وينبغي أن يكون الحوار مع الطلاب والطالبات صريحًا ومحدّدًا.
في نهاية الأمر فإن العلاقة بين الأهداف والحدود منوطة بالعلاقات بين المعلمين/ات والطلاب/ الطالبات. بهذا الصدد، ينبغي ألا ننسى، أنه عند وضع الحدود يتمّ تجديد الأمل والإيمان بالطالب.ـة. حتى في أوقات الأزمات يبقى الإيمان والأمل قائمين.التعاطف
في كثير من الأحيان لا يفهم المعلمون/ات مصطلح التعاطف. فكثيرًا ما يفهم المصطلح على أنه تساهل. وكأننا ملتزمون دائمًا "بتفهم" سلوك الطالب.ـة. هذا ليس تعاطفًا. ولا "أن تضع نفسك في مكان" الآخر هو التعاطف. فلا يمكننا أن نكون "في مكان الآخر" لأننا لم نمر نفس السيرورات العاطفية التي مرّها الآخر، ولأن السنّ مختلفة والخبرات مختلفة. التعاطف هو القدرة على تفسير، بأفضل الأدوات التي لدينا، ما الذي يحتاجه الطالب.ـة في هذه اللحظة. هنا والآن. بعد فهم الحاجة يجب أن يأتي رد الفعل. وهو لا يجب أن يكون بالضرورة "تضامنًا"، لأن هذا تحديدًا يمكن أن يكون "كعب أخيل" (نقطة ضعف) العلاقات بين الطلاب/ الطالبات وبيننا. ليس المطلوب منا أن نقوم بالتضامن، لأن الطلاب والطالبات يتوقعون/ يتوقعن أن نكون في موضع من التفهّم والتباعد في نفس الوقت: أن نكون الشخص الراشد الذي يمكنه أن يقود، ويرشد، ويساعد. هذا هو التعاطف.
معالجة فورية للأزمات:
بما أننا لم نبنِ لطلابنا وطالباتنا جنة على الأرض وإنما إطارًا نستطيع من خلاله أن نبني أملًا وإيمانًا، بالإضافة إلى المسؤولية والحدود، فلا يمكن ألّا نواجه حالات من التراجع والأزمات. وذلك لإننا لم ولا نغيّر الواقع كليًّا.
هذا يعني أن الأزمات ستدخل من الباب في كل وقت. وسوف تتغلغل في صفوف الطلاب والطالبات وستؤثر على قدرتهم/نّ على الجهوزيّة والتنبّه إزاء تلك التغييرات. فالإطار إذًا، بحكم تعريفه، هو ذو قابلية للأزمات في كل وقت. وعلينا أن نكون مستعدّين لذلك، ليس بالأدوات المناسبة فحسب، بل أن نكون أيضًا ذوي قدرة على التحمّل من أجل تجاوز الأزمة الحاليّة، حتى الكرّة التالية. تنبغي رؤية الأزمات على أنها فرص للتأكيد والتعبير عن الإيمان والأمل اللذين نتحلى بهما تجاه طلابنا وطالباتنا وعن القدرة على تذويت الحدود والأهداف. لا يمكن التنبّؤ بالأزمات مسبقًا بشكل كامل، ولكن بإمكاننا أن نعي أنها حتمًا قادمة وأنها ستسبب الأذى بالأساس لأضعف المستضعفين.
المعلم.ـة كوكيل.ـة تغيير:
الوظيفة المركزية للمعلم.ـة في وقت الأزمات وفي بيداغوجيا الأمل هي التمسك بالإيمان بقدرة الطالب.ـة على التغيّر. وهذه الرسالة ينبغي أن تُبلّغ كل الوقت. فالإيمان بالطالب.ـة ليس حدثًا لمرة واحدة، وإنما حالة متواصلة كل الوقت، بما في ذلك أوقات الأزمات، نوصل خلالها رسالة وتذكيرًا بأنّ إيماننا وثقتنا بهم/نّ وبالأمل بالتغيير مستمر إلى ما لا نهاية. بلا شروط وبدون علاقة بعدد الإخفاقات. كثيرًا ما يكون ذلك هو أهمّ شيء يفتقره طلابنا وطالباتنا: رسالة وكيل.ـة التغيير بأننا لا نتنازل تحت أي ظرف من الظروف وبأي شكل من الأشكال، حتى في أشدّ الأوقات صعوبة.
في كثير من الأحيان نعتقد أننا فشلنا، لأن الطالب.ـة، كما يبدو، لم يفِ/ تفِ بما وعد.ت، أو بسبب شعورنا بأننا لم ننجح "بدخول قلبه/ها". بالفعل، هذا هو،
إلى حدّ ما، حال الحوار والتفاهم بين الأطراف عندما يفشل. ومع ذلك، فإنّ هذا الوضع تحديدًا قد يعزز إدراك المعلم.ـة لنفسه/ها كوكيل.ـة تغيير. وأنّه تحديدًا في أعقاب الفشل، يمكن لاحقًا أن يحصل التغيير.
عقدة الإنقاذ:
ومع ذلك، علينا أن نكون واعين/ات ومتنبّهين/ات للوهم بأننا قادرون/ات على إنقاذ الجميع طوال الوقت. لا شيء أكثر خطورة من نهج كهذا، لأن عقدة الإنقاذ تؤدّي إلى تقليل قدر الإنسان الذي نعمل معه إلى مستوى العاجز غير القادر على تحمّل المسؤولية عن أفعاله. هذا تصرف لا يمنح الاستقلالية للشخص الذي نتعامل معه. بل بذلك نحوّله إلى متعلق بنا متّكل علينا وليس إلى مستقلّ.كل البشر يتأثرون الواحد.ة من الآخر/ الأخرى. نحن لا نعيش وحدنا في هذا العالم، والعالم لن يكون كائنًا إلّا إذا عشناه معًا. ومعًا معناها أن لكلّ واحد وواحدة القدرة على الاختيار وكذلك المسؤولية عن الاختيار. ونستثني من هذه القاعدة الأطفال صغار السنّ، لأنّ مقدرتهم/نّ على الاستقلالية في اتخاذ القرار هي أقلّ بطبيعة الحال.
علينا أن نكون واعين لهذه المتلازمة، لأننا كبشر، لا يمكننا تجنّب الاعتقاد بأننا "أعظم من الواقع"، وقد نخضع لهذا النزوة، خاصة أمام فئات مستضعفة.
الإيمان بالتغيير:
كنت قد أشرت في مقالات أخرى إلى أنّ أهمية المناعة، على صعيد المجموعة أو الإطار، تنبع من حاجتنا إلى بناء الأمل حتى في أوضاع وفترات يصعب فيها الحفاظ عليه. عندما يبدو لنا أنّ كل شيء من حولنا ينهار، عندما تتحطم الثقة بمجتمعنا، ولا أمل للتوصل إلى حلول، وفي كل الاحوال لن تكون الحلول سهلة، وأن المعاناة سوف تستمر، يهيمن علينا الإحباط ولا نملك الطاقات الداخلية لكي نخرج من الأزمة، ونوهم أنفسنا بأنّ الخلاص سيأتي من "الخارج". في كثير من الأحيان يكون هذا "الخارج" شخصًا ما قادرًا على إنقاذنا، أو أسوأ من ذلك: قادرًا على إنقاذنا من أنفسنا.
حقًّا، إنّ الإحباط الداخليّ والجماعيّ والاجتماعيّ يزداد شدةً ويؤدّي إلى تفاقم الأزمة. ولكي نخرج من الأزمة لا حاجة أن نكون ذوي قوى خارقة. علينا أن نكون نحن، كما كنا على مدى سنوات. عندما اخترنا أن نكون معلمات ومعلمين، قررنا أن نكون قادرين على إحداث التغيير، بواسطة إرشاد وتدريس الآخرين، وهذا الاختيار هو الذي قادنا إلى أن نكون جزءًا من واقع تربويّ واجتماعيّ. ليس لأننا أفضل، وإنما لأننا شعرنا بأننا قادرون على المساهمة بنصيبنا في هذا العالم، على كل المشاكل التي فيه، وأننا نفعل ذلك مع أناس، من رجال ونساء، حقيقيين.
وهذه رسالة أمل .

د. مرسيلو ڤاكسلر – حامل شهادة الدكتوراه في التربية، محاضر بموضوع الأولاد المعرضين للخطر، وعلم التربية الجماهيرية، وعلم التربية النقدية، وتغيير وعي المعلمين. ناشط اجتماعي ومنخرط في العمل التطوعي في أطر المجتمعات المستضعفة والأطفال المستضعفين.
